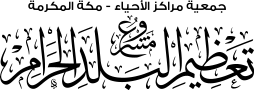إن حبّ الوطن غريزة فطر عليها كل مخلوق، ومفارقة الوطن تترك في النفس اضطرابا مهما كانت الغاية من مفارقته، والإنسان عندما يفارق وطنه على أمل العودة يعلل نفسه بسرعة الأيام، ويمنيها بأنس اللقاء بعد الفراق، أما إذا لم يكن أمل في العودة، وانقطعت آمال المهاجر في لقاء من فارق، وأصبح اللقاء أمنية عزيزة بعد أن كان حقيقة واقعة، فإن المهاجر يرى كل شيء بعين اليائس، ويسمع كل لحن بأذن الأصم، فهو لا يستلذ بعيش، ولا يهنأ براحة، ولا يأنس بجليس.[الهجرة النبوية-دراسة وتحليل].
فماذا عساه أن يكون الحال إذا كان ذاك الوطن هو بلد الله الحرام؛ مهوى الأفئدة؟!
سبق -في المقال السابق- تسليط الضوء على هجرة المسلمين إلى الحبشة؛ بحثًا عن الأمن الذي افتقدوه في مكة؛ بلد الأمن والأمان، حيث أشار عليهم النبي -صلى الله عليه وسلم- بذلك، ليتمكّنوا من إقامة شعائر دينهم بكل حرية في أجواءٍ مفعمة بالأمن والأمان؛ بعد تعرّضهم للمضايقات في مكة من قبل كفار قريش؛ الذين لم يراعوا حرمة بلد الله الحرام، ولم يعظّموه حقّ تعظيمه.
فلما رأت قريش أن أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- قد أمنوا واطمأنوا بأرض الحبشة، وأنهم قد أصابوا بها دارا واستقرارا؛ ائتمروا فيما بينهم أن يبعثوا إلى النجاشي وفدا منهم ليردّهم إليهم، فلما وصل الوفد إلى النجاشي وطلبوا منه أن يردّهم؛ أبى أن يجيبهم إلى ما طلبوا.
أقام المسلمون في أرض الحبشة يمارسون فيها شعائر دينهم بكل حريّة، ويعبدون ربهم عز وجل ويذكرونه آمنين مطمئنين.
وأما من بقي من المسلمين في مكة؛ فجعل البلاء يشتدّ عليهم من قبل المشركين، وضيقوا عليهم، ونالوا منهم ما لم يكونوا ينالون من الشتم والأذى، فشكا ذلك أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- واستأذنوه في الهجرة، فأذن لهم بالهجرة إلى المدينة، قائلاً لهم: "إني أُريت دار هجرتكم، ذات نخل بين لابتين، وهما الحرتان" قالت عائشة رضي الله عنها: فهاجر من هاجر قِبَل المدينة حين ذكر ذلك رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، ورجع إلى المدينة بعضُ من كان هاجر إلى أرض الحبشة من المسلمين، وتجهّز أبو بكر مهاجرا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (على رسلك، فإني أرجو أن يؤذن لي)، فقال أبو بكر: وترجو ذلك بأبي أنت وأمي؟ قال: (نعم)، فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحبته وعلف راحلتين كانتا عنده ورق السمر أربعة أشهر [رواه البخاري].
قال الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله تعالى: وهاجر المسلمون مرة ثانية ولكنها هجرة إلى ديار عربية، إلى قرية قُدّر لها أن تبقى الدهرَ كلَّه خاملة ضائعة وراء الرمال، حتى تتشرف بمحمد -صلى الله عليه وسلم-، فإذا هي أم المدائن، وعاصمة العواصم، منها تنبع عيون الخير والهدى لتسيح في الأرض، فتسقيها وتعمها بالخيرات، وإليها تنصب أنهار الملك والغنى والسلطان من كل مكان.[رجال من التاريخ].
لم تكن هجرة المسلمين من مكة إلى المدينة هينة سهلة، تسمع بها قريش، وتطيب بها نفسا، بل كانوا يضعون العراقيل في سبيل الانتقال من مكة إلى المدينة، ويمتحنون المهاجرين بأنواع من المحن، وكان المهاجرون لا يعدلون عن هذه الفكرة، ولا يؤثرون البقاء في مكة، وهم يعلمون أن معنى الهجرة إهدار المصالح، والتضحية بالأموال، والنجاة بالشخص فحسب، مع الإشعار بأنه مستباح منهوب، قد يهلك في أوائل الطريق أو نهايتها، وبأنه يسير نحو مستقبل مبهم، لا يدري ما يتمخض عنه من قلاقل وأحزان.[انظر: السيرة النبوية لأبي الحسن الندوي، والرحيق المختوم].
بدأ المسلمون يهاجرون، وهم يعرفون كل ذلك، وأخذ المشركون يحولون بينهم وبين خروجهم، لما كانوا يحسون من الخطر.
وأما رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقد أقام بمكة ينتظر أن يأذن له ربه -عز وجل- في الخروج من مكة؛ والهجرة إلى المدينة برفقة صاحبه أبي بكر -رضي الله عنه وأرضاه-.
وللحديث بقية..في المقال القادم والأخير إن شاء الله تعالى.
الباحث بمشروع تعظيم البلد الحرام