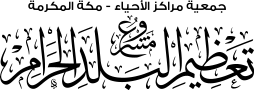في شهر رمضان المبارك من العام الثامن للهجرة النبوية حدث ذلك الحدث الجلل، والذي كان مؤذنًا بشروق فجرٍ جديد، ودخول الناس في دين الله أفواجا..إنه فتح مكة، ذلك الفتح المبين الذي أعزّ الله به دينه ورسوله وجنده وحرمه الأمين، واستنقذ به بلده وبيته من أيدي الكفار والمشركين.
وملخص تلك الحادثة كالتالي:
عندما بلغ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نبأُ نقضِ قريش وحلفائها من كنانة الاتفاق الذي تم إبرامه في صلح الحديبية؛ باعتدائهم على حلفائه من خزاعة؛ لم يتعجل صلى الله عليه وسلم في الزحف إلى مكة للانتصار لحلفائه المعتدى عليهم، كما يُلزمه بذلك ميثاق الحديبية، بل كرهًا منه لسفك الدماء، ورغبة منه في حقنها تقدم إلى قريش باقتراح يجنّب الفريقين ويلات الحرب..اقتراح في منتهى التسامح والتعبير الصادق المخلص عن الرغبة في الابتعاد عن إراقة الدماء، يتضمن تخيير قريش بين أمور ثلاثة:
- إما أن يدفع القرشيون وحلفاؤهم من كنانة ديات القتلى من حلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم، فتحقن بذلك الدماء من الفريقين
- وإما أن تتبرأ قريش من الغادرين الرئيسيين (كنانة) لينزل بهم الرسول صلى الله عليه وسلم العقاب العادل الذي استحقوه على بشاعة جريمة الغدر التي ارتكبوها في حق حلفائه.
- وإما الحرب.
غير أن قريشًا رفضت قبول العرضين العادلين الإِيجابيين الأوليين واختارت العرض الثالث؛ وهو الحرب، فتحدت الرسول صلى الله عليه وسلم وأبلغته أنها ترحب بالحرب وتفضلها على أن تدفع ديات قتلى حلفائه، أو تتبرأ من حلف قاتليهم البكريين.
وهنا كان لا بد للرسول صلى الله عليه وسلم من أن يفي بالتزاماته لحلفائه الخزاعيين المغدور بهم، وذلك حسب العهد الذي أعطاه لهم في وثيقة صلح الحديبية التاريخي.
لذلك -وبعد أن أصبح صلح الحديبية لاغيا بفعل تصرفات قريش وحلفائها- قرّر النبي صلى الله عليه وسلم الزحف إلى المشركين في مكة، لأنه اعتبر نفسه -بعد الذي حصل- في حالة حرب معهم كما كان قبل عقد ذلك الصلح.
وهكذا -وبناء على هذه المبررات- تحرك الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة في جيشه العظيم الذي بلغ عشرة آلاف مقاتل لتأديب الخائنين الناكثين، فداهم مكة على حين غفلة من أهلها المشركين الذين أخفى الله عنهم أنباء الغزو الشامل حتى وصلت طلائع الجيش النبوى ضواحي مكة، فأُسقط في أيدى زعمائها، فلم يسعهم إلَّا تسليم مكة للجيش النبوى دونما أية مقاومة تذكر، وقد كان فتح مكة -عكس ما يتصور زعماؤها- خيرًا وبركة عليهم.
دخل رسول صلى الله عليه وسلم مكة، ولكنه لم يدخلها دخول الفاتحين الجبّارين المستكبرين المتغطرسين، بل دخلها دخول الخاشعين المتواضعين حين رأى ما أكرمه الله به من الفتح، كان خاشعا لله، شاكرا لأنعمه، يقرأ سورة الفتح.
توجّه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو البيت، وأمر جيش المسلمين بتحطيم الأصنام، وتطهير البيت الحرام منها، وشارك صلى الله عليه وسلم في ذلك بيده، فكان يهوي بقوسه إليها فتتساقط على الأرض تحت الأقدام وهو يقرأ: {وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا} {قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ} وكانت الأصنام ثلاث مئة وستين صنمًا.
ورأى في البيت إبراهيم عليه السلام مصوَّرًا في يده الأزلام يستقسم بها؛ فقال (قاتلهم الله، جعلوا شيخنا يستقسم بالأزلام، ما شأن إبراهيم والأزلام، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين، ثم أمر بتلك الصور كلها فطُمست، ثم دخل صلى الله عليه وسلم الكعبة فصلى فيها ركعتين، ثمَّ استلم الحجر الأسود، وطاف بالبيت سبعاً مهللاً مكبراً ذاكراً شاكراً، فلما فرغ من الطواف بالبيت سبعاً، رقي إلى الصفا فاستقبل الكعبة وهلَّل وحمد الله، وأثنى عليه، ومجَّدهُ بما هو أهله ودعا بما شاء الله أن يدعو به، ولم يطف بين الصفا والمروة؛ لأنه لم يكن محرماً بعمرة، وأمر بلالاً أن يصعد فوق ظهر الكعبة فيؤذن، فصعد بلال وأذن للصلاة، وأنصت أهل مكة للنداء، وبعدها أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايع الناس على الإِسلام.
فتح مكة يتضمن أرقى الدروس وأعظم العبر التي يمكن للعاقل المنصف الحصيف أن يستخلصها ويعيها من تصرفات الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، سواء في العدل والإنصاف وشرف المعاملة، أو الوفاء بالعهد والوقوف عند شرف الكلمة، ثم العفو عند المقدرة.
عشرة آلاف مقاتل من المسلمين تسيطر على مكة، معقل أعظم وألدّ أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، ويلقي أهلها السلاح مقهورين، فيشملهم جميعًا عفو الرسول القائد والمنتصر، وهم الذين طالما تآمروا عليه وهدروا دمه وطاردوه تحت كل سماء، ولم يتركوا موطنًا كانوا يظنون أنهم قادرون على القضاء عليه فيه صلى الله عليه وسلم إلا وقاتلوه فيه، ومع ذلك: لم يجد شيء مما يصل إلى رؤوس القادة العاديين من نشوة الانتصار التي تجعل صاحبها يولغ في الدماء انتقامًا لنفسه ممن نكلوا به وأذلوا أصحابه يوم ضعفهم..لم يجد شيء من تلك النشوة يوم الفتح الأعظم سبيلًا إلى النبي القائد المنتصر صلى الله عليه وسلم، بل كانت الشفقة والرحمة والصفح والعفو والتسامح الطابع الوحيد لتصرف الرسول القائد المنتصر؛ في ذلك اليوم التاريخي.
"يا معشر قريش: ما ترون أنى فاعل بكم؟".
قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم.
قال: "اذهبوا، فأنتم الطلقاء".
تلك الكلمات النبوية توّج بها الرسول القائد انتصاره على أهل مكة حين ضمنها العفو العام عنهم وهو عند باب الكعبة. في الوقت الذي كانت فيه قلوب سادات مكة تركض بين جنوبهم خوفًا من أن ينتقم منهم لنفسه فيبعث بهم إلى القبور.
ولكنها أخلاق النبوة اصطنعت ببلسم العفو، والصفح والتسامح.